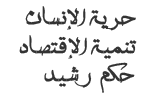من يملك قوة صناعة القرار في العالم، وتغيير المزاج العالمي وتحشيد الرأي العام والإعلام، وبيده مقاليد القرار العسكري والأمني والاقتصادي والسياسي في العالم، هو المسؤول في المقام الأول عن انحسار الحريات في العالم، ولا غرابة أنه بسبب الأداء الغربي البائس في دعم الأنظمة الشمولية والخطاب اليميني الذي انتشر في العالم الغربي فإن نتائج مؤسسة بيت الحرية فريدوم هاوس محبطة، ومتوقَعَة حول الانخفاض غير المسبوق في وضع الديمقراطية في العالم، وهي واحدة من أكبر النتائج “التي سجلناها على الإطلاق”، وفقاً لرئيس فريدوم هاوس مايكل أبراموتيز.
هناك عدد من الأسباب، حسب تقرير المؤسسة، التي جعلت العالم يصبح غير ديمقراطي في عام 2020، يمكن إرجاع الانخفاض في أكبر ديمقراطيتين في العالم، الولايات المتحدة والهند، إلى تأثير الحركات السياسية العرقية القومية اليمينية المتطرفة التي كانت تسيطر على تلك الدول. مكّن الوباء القادة الذين يميلون إلى الاستبداد في أماكن مثل المجر والفلبين من الاستيلاء على المزيد من السلطة لأنفسهم. استخدمت الصين نفوذها المتزايد لتقويض الحريات داخل حدودها وخارجها.
هذا الضعف العالمي للديمقراطية ليس جديداً وفقاً لبيانات فريدوم هاوس، شهدت كل سنة من السنوات الخمس عشرة الماضية نوعاً من التراجع. لكن عام 2020 هو أسوأ عام في ذلك “الركود الديمقراطي” برمته، كما تصفه المنظمة.
إن هنالك 42.6 % من دول العالم تعيش بحرية، و32.3 بالمائة يعيش أهلها بحرية جزئية و 25.1 بالمئة لا تعيش بحرية أبداً، وقد أعلنت مؤسسة فريدوم هاوس أن عام 2019 كان العام الرابع عشر على التوالي للتراجع العالمي للحرية، وقد اتسعت الفجوة بين الانتكاسات والمكاسب مقارنة بعام 2018، حيث شهد الأفراد في 64 دولة تدهور في حقوقهم السياسية والحريات المدنية بينما تلك الموجودة في 37 فقط شهدت تحسينات، وإن أكثر من نصف البلدان التي تم تصنيفها على أنها حرة أو غير حرة في عام 2009 عانى انخفاضاً صافياً في العقد الماضي.
تمثل الثورات والاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها العالم العربي، وخاصة سوريا، واضحة نتيجة طبيعية بسبب عدم تحقق تطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والعدالة وتعليم راق وعناية صحية تحترم إنسانيتهم وفرص عمل أفضل، وإن غياب ما سبق في أجندات وخطط التنمية الاقتصادية يسيء لكرامة المواطن مما يستحثه على الاحتجاج الذي يجابه بالقهر من قبل الحكومة، وتتفاقم الأزمة لتتحول إلى ثورة عارمة لا تبقي ولا تذر.
رغم عدم أمانة معظم الأنظمة الغربية في حماية مفهوم الديمقراطية في بعض الأحيان، وعدم مراعاتها المطالبة في تطبيقه لصيانة هذا المفهوم في دول العالم الثالث عموماً، لتفضيلهم المصالح السياسية والاقتصادية والتقسيمات الجيوبوليتيكية على تكريس مفهوم الديمقراطية في العالم بأسره، لكن هذا لا يعود على الديمقراطية “كمفهوم” بالنقد بقدر ما يلام صنّاع القرار العالمي على الإساءة للمفهوم الراق، وكذلك يوجه اللوم على من ائتمر بأمرهم من حكام دول العالم الثالث من الأنظمة الشمولية، الذين أجهضوا أو حاولوا إعاقة عدة تجارب ديمقراطية في العالم.
أغفلت مؤسسة فريدوم هاوس السبب الرئيس وراء تراجع موجة الديمقراطية، ألا يدعم الغرب والآن أمريكا الاتفاقية النووية الإيرانية، ويحرصون على عدم إزعاج إيران بشكلها الديكتاتوري والطائفي الذي دمّر العراق واليمن ولبنان وسوريا في سبيل مصالحهم اقتصادية؟
ألم تقف فرنسا ضد الشعب الجزائري وأخفقت التجربة الديمقراطية الجزائرية بمساندتها للانقلاب الذي قاده وزير الدفاع الجزائر خالد نزار في يناير/كانون الثاني عام 1992 على الرئيس الشاذلي بن جديد، الذي منح الأحزاب فرصة الوصول للحكم عبر تجربة ديمقراطية وليدة، لم يلبث “جنرالات فرنسا” أن قتلوها في مهدها وأشعلوا نيران “العشرية السوداء” لكي ينسى الجزائريون فكرة الديمقراطية وتداول السلطة؟
ألم يقف الغرب يتفرج على مذابح البوسنة في يوغسلافيا بإشراف الجنود الهولنديين ومراقبي الأمم المتحدة!
لم يذكر تقرير فريدوم هاوس مثلاً أن فرنسا وقفت ضد قرار اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أعلنت فوز المعارض فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 38,57 بالمئة من الأصوات، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، بل قام وزير الخارجية الفرنسية بالتشكيك فيها!
ولم يذكر التقرير كيف عرضت وزيرة خارجيتها ميشال أليو ماري قبل ثلاثة أيام من هروب بن علي، تقديم يد المساعدة وإرسال شرطة مكافحة الشغب الفرنسية لإخماد شرارة الثورة التونسية!
ألم يقل الرئيس الأمريكي جورج بوش قبيل غزو العراق إنه بمجرد الإطاحة بصدام حسين، فسيصبح العراق “منارة للديمقراطية في الشرق الأوسط”، هل نرى أن العراق عام 2021 هو حقاً “منارة للديمقراطية” في الشرق الأوسط؟ أم أن الأمريكيين والغرب عموماً قدّموا العراق هدية لإيران وخطاب التعصب الطائفي والديني، وسحق مفهوم المواطنة والعودة للهويات الفرعية الطائفية والعشائرية والمناطقية؟ بحيث بات بؤرة للقلق وليس للديمقراطية في العالم العربي.
ألم يقف الغرب مع الجنرال فرانسيسكو فرانكو الديكتاتور الذي حكم منذ نهاية الحرب الأهلية الإسبانية في عام 1939، وكان على الإسبان أن ينتظروا لعام 1975 حتى يتحولوا إلى الديمقراطية، بسبب وقوف الغرب “المبشر بالديمقراطية” مع الديكتاتور فرانكو ضد الشعب الإسباني؟
أما بالنسبة لمساندة الثورة السورية فإن أمريكا/أوباما حافظت لفترة طويلة على معادلة لا غالب ولا مغلوب، بحيث تحول دون انتصار الشعب المظلوم على مدى خمسة عقود، واتبعت طريقة استنزاف الشعب السوري وموارده، وأعطت الروس صلاحية استلام الملف السوري، ولم يكن يوفر جون كيري فرصة لينصح المعارضة السورية بأن يذهبوا لروسيا للتفاهم معها، وذلك من أجل إنجاح الاتفاق النووي الإيراني، وتسليم مقاليد الشرق الأوسط للمشروع الطائفي الإيراني كما فعلوا في العراق، والاكتفاء بالتصريحات والتعبير عن “القلق”، ووضع خطوط “حمر” لدرجة مستفزة ومكشوفة دون أي حراك، بحيث تتكرر تجربة إخفاق الثورة السورية الكبرى 1925.
مع بدء استلام الرئيس الأمريكي بايدن، وفريق أوباما الذي يحكم أمريكا عملياً، دخلت أمريكا ويتبعها الغرب في البدء بعملية تعويم نظام هجّر نصف سكان سوريا وقتل ما يفوق المليون، وقتل في سجونه وعذّب مئات الألوف، وعطّل قرارات الأمم المتحدة على رأسها 2254 وكل مسارات جنيف، وبالرغم أنه في ديسمبر/كانون الثاني 2016 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بتأييد 105 أعضاء، من أجل تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ولكن فريق أوباما/بايدن مصّرٌ على تسليم سوريا لإيران كما سلّمها العراق، وكمكافأة (حتى “يُحَلّي البازار” مع إيران) سحب الباتريوت من المملكة العربية السعودية كي لا تعترض صواريخ الحوثيين، الإيرانية ضد المملكة كرمى لعيون إيران، ثم يتبجحون بدعم الحريات والديمقراطية في العالم الثالث! والذي يثير الشفقة تسمية حزب بايدن/أوباما “الحزب الديمقراطي”!.
لا يبدو الغرب أميناً على القيم الديمقراطية خارج أرضه، بل إنه يعُدّ الديمقراطية مُنتَج حصري مثلها مثل البرامج المشفّرة على الكومبيوترات، يجب شراؤها وتجديدها بشكل دوري من قبل المنتج الحصري وتقوم شركة إنتاج “السوفتوير الديمقراطي” بتغيير “الكود الديمقراطي”، بما يتناسب وأجندات المُنتج الاقتصادية والسياسية وربما الأيديولوجي! فما يجوز للغرب لا يجوز للعرب رغم أن بين الكلمتين “نقطة” فقط!
هذا ليس جديداً بل هو استمرار لنهج عمره أكثر من قرن من الزمان على الأقل، ويؤكد على هذا الفهم المؤرخة الأستاذة إليزابيث ف. تومسون في كتابها “كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب: المؤتمر العربي السوري عام 1920 وتدمير تحالفه الليبرالي الإسلامي التاريخي”، (صدر عام 2020)، حيث أكّدت أن “المؤتمر العربي السوري قد أعلن الاستقلال في 8 مارس/آذار 1920 وتوج فيصل ملكاً لـ “ملكية تمثيلية مدنية”، وأصبح الشيخ راشد رضا، أبرز مفكر إسلامي في ذلك الوقت، رئيساً للبرلمان وأشرف على صياغة دستور أنشأ أول ديمقراطية عربية في العالم، حسب تومسون، وضمن حقوقاً متساوية لجميع المواطنين، بمن فيهم غير المسلمين”. لكن الغرب أخفق هذه التجربة وحاربها!
لن يمنح الغرب “الكود الديمقراطي” للعالم الثالث بسهولة، ودون تسييس للمسألة إلا في حالات استثنائية، وهذا الكود بمثابة الشيفرة التي تُشغّل “برنامج الديمقراطية” على “الحواسيب السياسية” للشعوب المتعطشة للحرية، هذا الأسلوب في التعامل عابر للأخلاق ولموازين الحق والعدل، وفي كل مرة يصطدم دعاة الحرية والعدل في العالم الثالث من موقف الغرب الصادم من حركات التحرر في بلادهم، لأنه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت المصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وطبقاً للأمزجة الغربية صاحبة الشيفرة، ولعل مؤسسة فريدوم هاوس تستدرك هذا التشخيص في تقاريرها القادمة بصراحة مؤلمة ومؤسفة.
د.أسامة قاضي