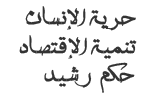فورن أفيرز – ترجمة وتحرير فريق تلفزيون سوريا
نشرت مجلة “فورن أفيرز” (Foreign Affiars ) الأميركية مقالاً بعنوان “كيف دعمت مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية نظام الأسد؟”، لتسليط الضوء على الاستفادة الكبيرة التي جناها نظام الأسد من المساعدات المقدمة من الدول نفسها التي فرضت عليه عقوبات اقتصادية تعد الأشمل على الإطلاق.
لماذا لم تنجح العقوبات في وقف آلة قتل الأسد؟
ذكرت الصحيفة أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام في سوريا منذ نيسان 2011 تُعد الأكثر شمولاً على الإطلاق، لكنها لم تكن ذات جدوى نتيجة فشل الدول في عزل الأسد عن السلطة، ورغم الدعم الكبير الذي تلقاه النظام من حلفائه مثل روسيا وإيران وحزب الله، إلا أن جزءًا كبيراً من اللوم يقع على الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا، حسب الصحيفة.
فقد سمحت وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، لنظام الأسد بالسيطرة على الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، باستخدام أموال المانحين لتفادي العقوبات ودعم الجهود العسكرية لقواته، والجدير بالذكر أن الجزء الأكبر من هذه المليارات مُقدّمة من قبل نفس الحكومات الغربية التي فرضت العقوبات.
وأشارت الصحيفة إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بإصلاح نظامها لتقديم المساعدات، بعد أن ثبت قدرة النظام على “اختطاف” التمويلات المالية الأكبر، وشددت على الإسراع في إصلاح ذلك قبل أن يكرر النظام نداءاته ضمن نفس التكتيكات للحصول على مساعدات إعادة الإعمار.
قواعد الأسد
تعود جذور مشاكل الأمم المتحدة في سوريا إلى ربيع عام 2012، عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” (OCHA) بالتعبئة لتقديم المعونة إلى سوريا، أصرّ النظام على أن تدير “الأوتشا” جميع عملياتها في دمشق.
استفاد النظام بشدة من كونه ما زال عضواً في الأمم المتحدة واستعان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، والذي ينص على أنه “ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر، وأن الدولة المتضررة لها الدور الرئيسي في بدء المساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها”، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى القبول بذلك، وسرعان ما تدفقت 216 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للنظام، وهو مبلغ وصل إلى أكثر من 3 مليار دولار سنوياً في السنوات اللاحقة.
سمح كل ذلك للنظام بالسيطرة على جهود الإغاثة، وذلك عبر “الهلال الأحمر العربي السوري”، الشريك الرسمي للنظام، الذي أصبح المخوّل بتنسيق الجهود الإغاثية، ولا يمكن إجراء زيارات ميدانية إلا بإذن منه.
وأوضحت الصحيفة أنه قد تم ربط الهلال الأحمر منذ فترة طويلة بأجهزة النظام في سوريا، وتم إقصاء أي إشارة لاستقلاله بعد عام 2011، عندما أجّل النظام انتخابات الهلال الأحمر لأجل غير مسمى، وطرد أعضاءه المستقلين، وطرد الموظفين المؤهلين.

وقام النظام أيضاً بدس عملائه كمتطوّعين ضمن الهلال الأحمر السوري، وفقاً لما أفاد به متطوعون سابقون تم طردهم أو أصبحوا مطلوبين لأجهزة النظام الأمنية.
بعد هذه التغييرات، أصبحت السياسة الجديدة للهلال الأحمر توصيل المساعدات وفقًا للمعايير الحزبية، بعد أن تم اعتقال الموظفين والمتطوعين الذين انتهكوا هذه القواعد وتعرضوا للتعذيب، بل وقتلوا.
ومن خلال إصدار تأشيرات انتقائية لموظفي المنظمات الإنسانية الدولية، فضّل النظام رعايا الدول الحليفة، وبذلك تمكن من فرض رقابة صارمة على توزيع المساعدات والإمدادات الطبية، والتي لا تمنعها فقط عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة مثل إدلب، ولكن أيضا من تلك التي مثل الغوطة الشرقية، التي كانت تحت الحصار في السابق.
وكالات الإغاثة الدولية عبر الحدود
لتجنب سيطرة النظام، فضّل العديد من وكالات الإغاثة الدولية العمل عبر الحدود من تركيا أو الأردن، والعمل مع الشركاء السوريين للوصول إلى ملايين المدنيين اليائسين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وتم إثبات فعالية هذا النهج خلال تفشي مرض شلل الأطفال في عام 2013، حيث ظلت منظمة الصحة العالمية ومقرها دمشق هادئة طوال شهور، في حين أنكر النظام حدوث تفشٍّ للمرض. في غضون ذلك، أثبتت المنظمات غير الحكومية السورية التي تعمل عبر الحدود من تركيا أن شلل الأطفال قد عادت إلى سوريا وأجرت حملة تطعيم جماعية ناجحة.
وقام النظام في نسيان من عام 2014 بطرد منظمة “ميرسي كور” غير الحكومية من دمشق، لأنها كانت تعمل على تقديم مساعدات إنسانية فعالة خارج سيطرة الأسد.
في يوليو 2014، بعد أن وافقت روسيا على حجب حق النقض، تبنى مجلس الأمن الدولي رسميًا القرار رقم 2165، والذي يجيز المساعدة عبر الحدود، ما مثّل علامة بارزة في تحديد أولويات المساعدات الإنسانية على السيادة.

ومع ذلك، استمرت وكالات الأمم المتحدة، غير الراغبة في إفساد العلاقات مع النظام، في إعطاء الأفضلية لعملياتها في دمشق، ومنحها نفوذاً هائلاً للنظام.
وفي مثال صغير لكن مؤثر لآثار هذه النفوذ، بدأت منظمة الصحة العالمية في عام 2014 بنشر خريطة الأسد المفضلة لسوريا، والتي تضم جزءاً كبيراً من تركيا. والأهم من ذلك، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قام باستخدام مصطلحات النظام المضللة في خطته للاستجابة الإنسانية لعام 2016.
فقد استخدم “الصراع” بدلاً من “الأزمة”؛ “المواقع المدرجة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة” بدلاً من المناطق المحاصرة. كما ألغى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) برمجة إزالة الألغام لأنه كان سيعمل عبر الحدود خارج نطاق سيطرة الأسد.
العائدات المالية الضحمة للنظام عبر التحايل على الأمم المتحدة
لم تُحد قرارات الأمم المتحدة بالعمل انطلاقاً من دمشق من فعالية تقديم المساعدات، بل إنه مكّن نظام الأسد من إعادة توظيف الأموال الدولية لتحقيق غاياته الخاصة، وقدمت جهود الإغاثة في سوريا تدفقات هائلة من الأموال، لنظام يعاني من شلل اقتصادي.
ويشير تقرير غير منشور من قبل المركز السوري لأبحاث السياسات على سبيل المثال، إلى أنه في عام 2017 كانت النفقات الإنسانية الإجمالية للمجتمع الدولي في سوريا تعادل نحو 35 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
وأدرك النظام باكراً أن تدفقات الأموال هذه ستطغى على قدرات الهلال الأحمر. ونتيجة لذلك، أنشأت الحكومة في عام 2013 لجنة الإغاثة العليا، وهي وكالة مكلفة بتنسيق طلبات الأمم المتحدة للوصول إلى المساعدات الإنسانية مع الوزارات الحكومية الرئيسية والفروع المختلفة لقوات المخابرات.
وسمح ذلك للنظام بالتحكم في مَن يتلقى الإغاثة، أين، ومتى. رغم أن كل من وزارة الصحة ورؤساء القوات الجوية والاستخبارات العسكرية يخضعون لعقوبات بريطانية وأمريكية وأوروبية.
وفرض النظام ضرائب على مرتبات جميع موظفي الإغاثة، تتراوح من 5% للموظفين الوطنيين الأقل أجراً إلى 20 % للموظفين الدوليين، وتساعد أموال الضرائب هذه بدعم العمليات العسكرية للنظام وملئ جيوب المسؤولين لديه.
وتطلب وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية من المنظمات التي تعتمد على شركاء تنفيذيين محليين (وهي وكالات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية) أن تختار شركاءها من قائمة “المنظمات غير الحكومية”، هذه العبارة الأخيرة هي تعبير ملطف عن الكيانات الخاضعة لسيطرة النظام مثل “أمانة سوريا” التي أسستها وترأستها أسماء الأسد، أو شركات متخفية في هيئة جمعيات خيرية مثل “البستان” التي يملكها رامي مخلوف.
وتخضع كل من أسماء الأسد ومخلوف للعقوبات الدولية، وكذلك وليد المعلم وزير خارجية النظام وليد المعلم. وفي مايو 2017، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية “البستان” إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. ومع ذلك، وبما أن الأمم المتحدة لا تطلب من المنظمات الشريكة لها الكشف عن شركائها في التعاقد الفرعي، فإن المنظمات غير الحكومية الوطنية مثل “أمانة سوريا” ما تزال قادرة على التعاقد مع “البستان” والكيانات المماثلة، وتوجيه أموال الأمم المتحدة إلى زعماء النظام.
ويفرض النظام على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية شراء الهواتف المحمولة من سيريتل، وهي شركة أخرى لمخلوف. كما تجبرهم على استيعاب موظفيها الدوليين البالغ عددهم 150 موظفاً في فندق فور سيزونز دمشق، المملوك بشكل مشترك من قبل وزير السياحة سامر الفوز، وهو رجل أعمال متحالف مع النظام ومسؤول عن الاستيلاء على ممتلكات النازحين وفق القانون رقم 10.

لقد استفاد النظام من وكالات الإغاثة من خلال اللعب بأسعار الصرف أيضًا. فقد فرض على الأمم المتحدة أن تُدفع الأموال اللازمة لبرامجها، ورواتب موظفيها، وثمن الأدوية والسلع والخدمات المحلية إلى البنك المركزي بالدولار بسعر الصرف الرسمي، وهو ما يقل بنسبة 20 إلى 25 في المائة عن سعر السوق السوداء، ويذهب هذا الفارق إلى جيب النظام.
ووفق تقدير معتدل يستخدم بيانات خدمة التتبع المالي للأوتشا (OCHA)، فإن هذه التلاعبات أنتجت ما لا يقل عن مليار دولار من الإيرادات للنظام.
الأمم المتحدة تدعم وزارة الدفاع عبر بنك الدم
يتجلى استخدام نظام الأسد لكيانات الأمم المتحدة لتفادي العقوبات من خلال استخدام منظمة الصحة العالمية لأموال المانحين لشراء إمدادات نقل الدم نيابة عن وزارة دفاع النظام، التي تسيطر على بنك الدم الوطني. وبالتالي، فإن منظمة الصحة العالمية تدعم فعليًا نفس الوزارة التي تقصف المدنيين وتهاجم المستشفيات وتحجز المساعدات المنقذة للحياة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
النظام حصل على 99% من المساعدات الدولية لسوريا
في عامي 2012 و2013، ذهبت جميع مساعدات الأمم المتحدة (1.2 مليار دولار) إلى النظام مباشرة. في عام 2014، بلغ إجمالي المساعدات الدولية للأمم المتحدة (1.2 مليار دولار) ولم يذهب سوى 6.5 مليون دولار لوكالات دولية تعمل عبر الحدود من تركيا، بينما ذهب أكثر من مليار دولار إلى وكالات الأمم المتحدة في دمشق.
واستمر هذا النمط في عام 2015، حيث تلقت المنظمات غير الحكومية السورية العاملة عبر الحدود أقل من 1% من إجمالي ميزانية الأمم المتحدة للمساعدات لسوريا.
أفضل تقدير هو أن ما بين 2 و18 % فقط من معونات الأمم المتحدة للنظام تصل فعلياً إلى السوريين المحتاجين. ونادراً ما تذهب تلك المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وغالباً ما تكون تحت الحصار.

وبدلاً من مساعدة المدنيين المعرضين للخطر، عززت المساعدات حكومة النظام، والمفارقة الحزينة هي أن القوى الدافعة وراء العقوبات ضد حكومة النظام (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) كانت أكبر ممولي الاستجابة الإنسانية التي قوضت تلك العقوبات.
وقت التغيير
إذا كان هناك من أي وقت مضى حالة يجب على وكالات الأمم المتحدة فيها أن تنفصل عن احترامها التقليدي للسيادة، فهي في سوريا. لقد حان الوقت لإعادة النظر في اتفاقهم مع الشيطان ودراسة ما إذا كان وجودهم في دمشق أكثر ضرراً من النفع.
تواصل وكالات الأمم المتحدة تبرير قرارها بالعمل مع النظام على أساس الناحية العددية البحتة، حيث يعيش معظم الناس المحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. ومع ذلك، ما تزال الوكالات غير قادرة على الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً، مثل أولئك الذين بقوا في الغوطة الشرقية بعد استيلاء قوات النظام عليها في وقت سابق من هذا العام.
واليوم تعد محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا أكبر مناطق الاحتياج المتبقية، حيث يوجد بها ثلاثة ملايين مدني.
وفي حال قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجديد “التفويض عبر الحدود” الوارد في القرار 2165، فذلك سيسمح لوكالات الأمم المتحدة بالوصول إلى هؤلاء المدنيين مباشرة من تركيا، دون العمل من خلال النظام. لكنه إذا بقيت الوكالات في دمشق، فسيتم منعهم من مساعدة المدنيين في إدلب مع استمرار النظام وحلفائه في حملتهم الدموية لاستعادة السيطرة على المحافظة.
وفي الوقت الذي تشارف فيه الحرب على الانتهاء، بدأت حكومة النظام في التوسّل للحصول على مساعدات إعادة الإعمار، الأمر الذي يدفع إلى المطالبة بشكل أكبر باستقلال وكالات الأمم المتحدة.

وإذا كان نظام الأسد يريد مساعدة دولية لإعادة بناء المدن التي لعب دوراً مركزياً في تدميرها، فعليه أن يفعل ذلك بشروط مختلفة جذرياً، ويجب على المانحين الدوليين أن يكونوا الجهة الوحيدة المخولة باختيار الشركاء المحليين، ورفضهم رفضاً قاطعاً الخضوع لأساليب النظام في توجيه أموال المساعدات لأغراضه الخاصة.
كما يجب بدء إجراء تدقيق قانوني شرعي لتحديد كيف أن الأمم المتحدة أنفقت ميزانيتها التي تبلغ قيمتها مليار دولار في سوريا.
الدرس المستفاد من سوريا هو أن الدافع الإنساني لا يكفي، فقد نجت وكالات الأمم المتحدة لوقت طويل من التمحيص والتدقيق، عبر التلويح براية النوايا الطيبة. لكن لم يعد بوسعنا أن نتجاهل النتائج المروعة التي أنتجتها هذه النوايا الحسنة في سوريا.
وإذا لم تتمكن الأمم المتحدة من تحسين الشروط التي تعمل عليها بشكل جذري في البلاد، يجب عليها أن تخرج إلى أن يتوقف نظام الأسد الوحشي الذي لا يوصف عن فرض نفسه على الشعب السوري.